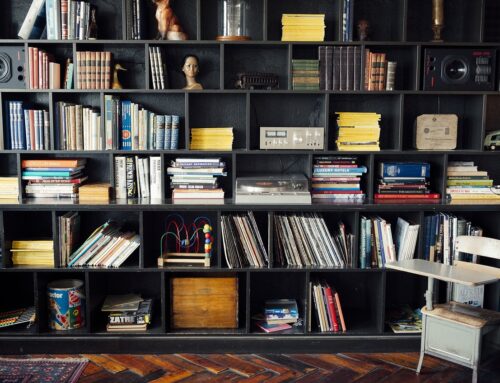لمحة عن المقال
- المفعول لأجله مع الأمثلة – النحو العربي
- لمحة عن المقال
- المفعول لأجله في اللغة العربية
- تعريف المفعول لأجله
- شروط نصب المفعول لأجله
- علامة الإعراب
- حالات المفعول لأجله من حيث الإعراب
- الفرق بين المفعول لأجله والمفعول المطلق
- التمارين والتدريبات الصفية على المفعول لأجله
- أهمية تعليم المفعول لأجله للطلاب
- أخطاء شائعة يجب التنبه لها
- المراجع
المفعول لأجله في اللغة العربية
تُعَدّ اللغة العربية من أغنى اللغات من حيث التعبير الأسلوبي والدقة النحوية، إذ تمنح متعلِّميها أدوات نحوية تساعدهم في توضيح المعاني وتوسيع دائرة التفاهم بين المتحدثين. ومن بين هذه الأدوات النحوية الأساسية، يأتي المفعول لأجله، وهو أحد المنصوبات التي تُستخدم لتوضيح السبب الذي من أجله حدث الفعل. يُعرف أيضًا بمصطلح “المفعول له”، وهو اسم منصوب في الجملة يبيِّن سبب حدوث الفعل، ويُضفي دقة ووضوحًا على التعبير اللغوي.
تعريف المفعول لأجله
هو اسم منصوب يُذكر في الجملة لبيان سبب وقوع الفعل، أي أنه يوضّح الدافع أو الغرض الذي دفع الفاعل للقيام بالفعل، دون أن يكون هذا الدافع زمنًا أو مكانًا للفعل. ويشترط في المفعول لأجله أن يكون مصدرًا قلبيًّا عامًا، مثل: حبّ، خوف، رغبة، حرص، غضب، شكر، إجلال، طمع، وغيرها من المشاعر أو النوايا التي تحرك الإنسان.
مثال توضيحي:
جملة: درستُ رغبةً في النجاح.
في هذه الجملة: “رغبةً” هي المفعول لأجله، وهي السبب الذي من أجله قام المتكلم بالفعل “درستُ”. فالمتكلم درس بسبب رغبته في تحقيق النجاح.
شروط نصب المفعول لأجله
لكي يُنصَب الاسم على أنه مفعول لأجله، لا بد أن تتحقق فيه الشروط التالية:
1. أن يكون مصدرًا قلبيًا:
أي أن يكون المفعول لأجله يدل على شعور أو دافع داخلي كمشاعر الحب أو الخوف أو الرغبة، لأن هذه المشاعر هي التي تدفع الإنسان إلى القيام بالفعل.
2. أن يكون قلبيا عامًا:
أي أن لا يكون مخصوصًا بأمر ضيق أو شخص معين. فمثلاً لا يُعتبر “رغبة محمد” مفعولًا لأجله، لأن الرغبة منسوبة إلى شخص مخصوص، بينما المقبول هو: “رغبة”، بصيغة المصدر العام.
3. أن يكون السبب متحدًا مع الفعل في الزمان والفاعل:
يشترط أن يكون وقوع الفعل والمفعول لأجله من نفس الفاعل، وأن يحدثا في نفس الزمن. فإن اختلف الفاعلان أو تضاربت الأزمان، لا يُعرب المصدر مفعولًا لأجله.
أمثلة توضيحية:
1. صمتُّ احترامًا للكبير: “احترامًا” مفعول لأجله لأنها سبب للسكوت. الفعل “صمتُ” والسبب “احترامًا”، والفاعل واحد، والزمن واحد.
2. ركضتُ خوفًا من العقاب: “خوفًا” مصدر قلبي عام، وهو سبب الركض.
3. جاهدَ المجاهدون طمعًا في الشهادة: “طمعًا” هو المفعول لأجله، يوضّح سبب الجهاد.
علامة الإعراب
المفعول لأجله يكون منصوبًا دائمًا.
1. إذا كان مفردًا:
فإنه يُنصب بالفتحة الظاهرة، مثل: “احترامًا”، “حبًّا”، “خوفًا”.
2. إذا كان مثنّى:
فإنه يُنصب بالفتحة، مثل: “شكرَ والدَيهِ امتنانًا لِجودهما”.
3. إذا كان جمع مذكر سالم:
فإنه يُنصب أيضًا بالفتحة، مثل: “ساعدتُ الفقراء رغبةً في الثواب”.
4. إذا كان جمع تكسير:
فإنه يُنصب بالفتحة الظاهرة، مثل: “اجتهدتُ تحقيقًا للأهداف”.
حالات المفعول لأجله من حيث الإعراب
المفعول لأجله يأتي في حالتين رئيسيتين حسب توافقه مع شروط النصب:
أولًا: منصوب ظاهر:
وفي هذه الحالة يكون المصدر القلبي متوافرًا فيه جميع الشروط الأربعة السابقة (أن يكون مصدرًا قلبيًا عامًا، وأن يتحد مع الفعل في الفاعل والزمان). مثل:
– ضحّيتُ حبًّا للوطن.
– سافرتُ طلبًا للعلم.
ثانيًا: مجرور بحرف جر:
إذا لم تتوافر جميع الشروط السابقة، يحتاج المفعول لأجله إلى حرف جر لربطه بالفعل كأن يُقال: “من أجل”، “لأجل”، “بسبب”، “لِ”، وغيرها من حروف الجر الدالة على السبب.
أمثلة:
– قرأتُ الكتاب من أجل الامتحان.
– ذهبتُ للمستشفى لأجل العلاج.
في هذه الأمثلة، السبب لم يتحد مع الفاعل في بعض الأحيان، أو لم يكن مصدرًا قلبيًا عامًا؛ لذا لا يُعرب مفعولًا لأجله، بل يكون اسمًا مجرورًا بحرف الجر الدال على التعليل.
الفرق بين المفعول لأجله والمفعول المطلق
قد يختلط على الدارسين التفريق بين المفعول لأجله وبين المفعول المطلق، لكن هناك فروق دقيقة توضح الاختلاف بينهما:
المفعول لأجله
يدل على سبب ودافع وقوع الفعل، ولا يشترط أن يُشتق من نفس الفعل.
مثال: سافرتُ رغبةً في العلم.
المفعول المطلق
يُذكر لتأكيد الفعل أو بيانه أو عدده، وغالبًا ما يكون مشتقًا من نفس الفعل.
مثال: سافرتُ سفرًا طويلًا.
التمارين والتدريبات الصفية على المفعول لأجله
لتمكين الطلاب من فهم واستيعاب هذا النوع من المفاعيل، يمكن للمعلم استعمال التمارين التطبيقية المختلفة، مثل:
تمرين 1: استخرج المفعول لأجله من الجُمَل الآتية:
1- عملتُ بجدٍّ طمعًا في التقدير.
2- أطعتُ والدي حبًّا لهما.
3- تركتُ الكسل حرصًا على التفوق.
تمرين 2: ضع مفعولًا لأجله مناسبًا في الفراغ:
1- كتبَ الطالبُ الدرسَ (……….) للفهم.
2- قرأتُ القرآن (……….) في رضا الله.
تمرين 3: ميّز المفعول لأجله من غيره:
1- شرحتُ الدرسَ شرحًا وافيًا.
2- حفظتُ الدرس حرصًا على النجاح.
3- ذَهَبْتُ إلى المدرسة بسبب الامتحان.
أهمية تعليم المفعول لأجله للطلاب
يُعد فهم المفعول لأجله مفتاحًا أساسيًا لإتقان التفكير التحليلي في اللغة، لأنه يُعلّم الطالب كيف يربط بين الأفعال وغاياتها، مما يطوّر مهارات التواصل الكتابي والشفهي. كما أنه يُنمّي القدرة على التعبير الدقيق عن المشاعر والدوافع، وهو ما يساعد في تحسين كتابة الإنشاء والتعبير ويفتح المجال أمام الطلاّب لاستخدام أساليب بلاغية تهدف إلى الإقناع والتأثير. ويُمكن للمعلمين والآباء أن يتابعوا ملاحظة استعمال الأطفال لهذه القاعدة في كتاباتهم اليومية وتحفيزهم على إدخال المفعول لأجله في جُملهم.
كما أن تعليم هذه القاعدة يمدّ الطالب بإدراك أعمق لأساليب البيان في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ويجعله قادرًا على تفسير المعاني بشكل أدق.
أخطاء شائعة يجب التنبه لها
يقع بعض الطلاب في أخطاء متكررة عند استخدام المفعول لأجله، نذكر منها:
1. استخدام غير المصدر:
مثل: “سافرتُ لأنني فضولي” – وهذا تعبير غير نحوي. الصحيح: “سافرتُ فضولًا” أو “حبًّا في الاكتشاف”.
2. استخدام اسم غير قلبي:
كأن يقول الطالب: “جلستُ مسجدًا” – وهذا خطأ لأن “مسجدًا” لا يدل على دافع أو شعور.
3. اختلاف الفاعل بين الفعل والمصدر:
مثال: “أتى الطالبُ احترامَ المعلمِ”؛ الفاعل هنا الطالب، ولكن الاحترام منسوب إلى المعلم، لذلك لا يصح إعرابه مفعولًا لأجله.
المفعول لأجله من القواعد الهامّة التي تُمكِّن الطلّاب من التعبير عن دوافعهم وأهدافهم بوسيلة نحوية دقيقة وبليغة. وعلى المربيين والمعلمين أن يحرصوا على تدريبه في الحصص الدراسية من خلال الشرح والتطبيق المستمر، ومراعاة الأعمار والمستويات الدراسية عند استخدام التمارين. كما يُستحسن دعم الطالب بالنماذج العملية المستخلصة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية والقصص التربوية المعاصرة، لتكون اللغة العربية أداة فعالة للتعبير عن القِيَم والمبادئ والمعارف.
المراجع
1. عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة.
2. تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، مكتبة الأنجلو المصرية.
3. مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، دار الفكر اللبناني.
4. وزارة التربية والتعليم – مصر، كتاب النحو للمرحلة الإعدادية والثانوية.
5. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.