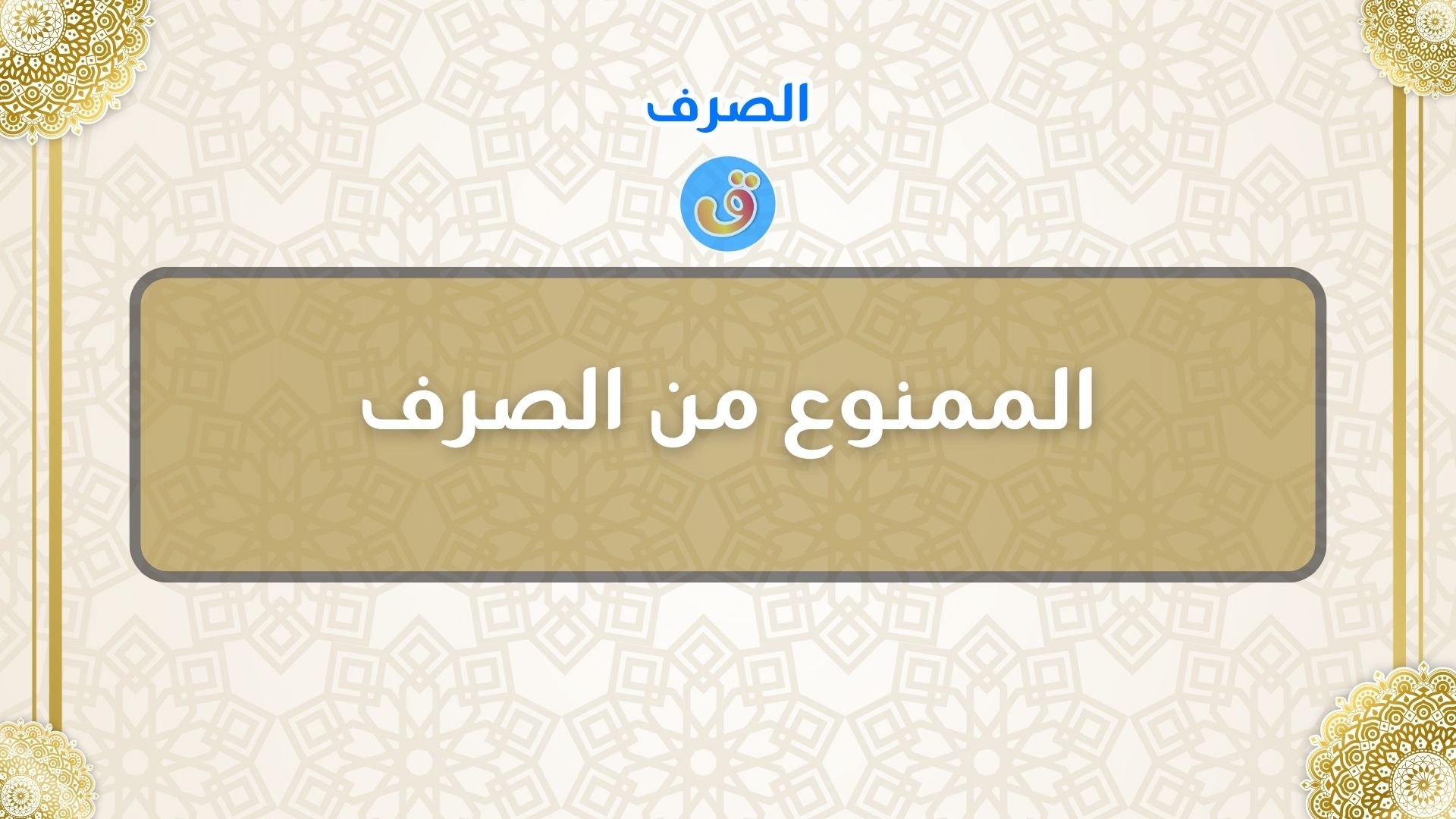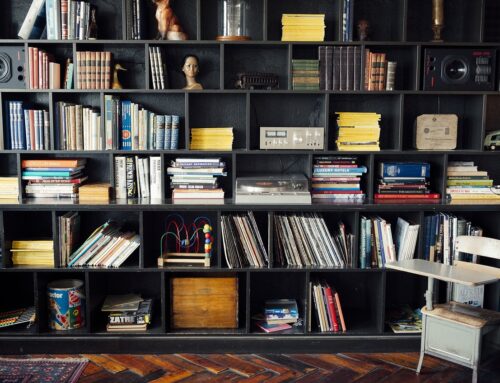لمحة عن المقال
حالات صرف الممنوع من الصرف مع الأمثلة
الممنوع من الصرف هو اسمٌ لا يأخذ التنوين في حالته الأساسية، ولا يجرّ بالكسرة بل يُجرّ بالفتحة في بعض المواضع. ويعد هذا الموضوع من المواضيع النحوية المهمة في اللغة العربية والتي ينبغي للطلبة تعلّمها منذ المراحل الابتدائية، لفهم بناء الجمل الصحيحة، واكتساب المهارات اللغوية اللازمة للنطق والكتابة السليمة. تندرج هذه القاعدة ضمن علم النحو، وتُدرّس عادة في المرحلة الإعدادية فما فوق، لكنها تحتاج إلى أسلوب مبسّط وفهم متدرج يناسب الفئة العمرية المُتعلمة.
ما هو الاسم الممنوع من الصرف؟
الاسم الممنوع من الصرف هو اسم معرب لا يُنوَّن (أي لا يُضاف إليه التنوين)، ولا يُجرّ بالكسرة، إلا في حالات معينة سنتعرّف عليها لاحقًا. هذا الاسم يكون مرفوعًا بالضمة، ومنصوبًا بالفتحة كما هو الحال في الأسماء المُعرَبة الأخرى، لكن في حالة الجر، يُجرّ بالفتحة عوضًا عن الكسرة، وهو السمة الأبرز للممنوع من الصرف.
الممنوع من الصرف نوع من التنوّع في البناء اللغوي العربي، ويخضع لقواعد وأسباب محددة تجعله غير قابل للتنوين. ويمكن تلخيص مظاهر المنع من الصرف في أمرين:
- عدم قبوله للتنوين.
- جرّه بالفتحة النائبة عن الكسرة إذا لم يكن معرفًا بـ”أل” ولم يضف إلى كلمة أخرى.
أسباب منع الاسم من الصرف
توجد عدة أسباب تؤدّي إلى منع الاسم من الصرف، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: أسباب معنوية وأسباب لفظية. هذه الأسباب تُساعدنا في معرفة إن كان الاسم ممنوعًا من الصرف أم لا.
أولًا: الأسباب المعنوية
وهي الأسباب التي ترتبط بمعنى الاسم وليس بتركيبه اللفظي، ومنها:
1. العلمية
معنى العلمية أن الاسم يدل على اسم علم معين، أي هو اسم لشخص أو مكان أو شيء معين مثل: “عمر”، “مصر”، “خالد”.
2. الوصفية
ويُقصد بها أن الاسم يدل على صفة، مثل: “أفضل”، “أحمر”، “أكرم”، “أحسن”.
ثانيًا: الأسباب اللفظية
وهي ما يتعلق بشكل الكلمة وصيغتها، مثل:
1. على وزن “أفعل” الذي مؤنثه “فَعلاء”
مثل: “أحمر – حمراء”، “أصفر – صفراء”.
2. صيغة منتهى الجموع
مثل: “مساجد”، “مصابيح”، “قوانين”، “شوارع”. وهي الصيغة التي تكون على وزن “مفاعل”، “مفاعيل”، “فواعل”، “فعائيل”، وغير ذلك من أوزان الجمع التي تنتهي بألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف، الأوسط منها ساكن.
أنواع الممنوع من الصرف مع الأمثلة
للممنوع من الصرف عدة أشكال وأنواع، وكل نوع له قاعدة خاصة به يستند إليها في منع صرفه. وفيما يلي أهم الأنواع:
1. العلم الممنوع من الصرف
يُمنع الاسم العلم من الصرف إذا توفرت فيه إحدى الحالات التالية:
أ. العلمية وزيادة الألف والنون
مثل: “سليمان”، “عثمان”، “عمران”.
مثال في جملة: سافرتُ إلى عُثمانَ.
ب. العلمية والتأنيث
ومنه أسماء البنات: “فاطمة”، “زينب”، “مريم”.
مثال في جملة: قرأتُ عن فاطمةَ.
ج. العلمية والتركيب
ويكون في الأسماء المركبة مثل: “بعلبك”، “حضرموت”.
مثال: زرتُ حضرموتَ.
د. العلمية والعجمة
أي أن يكون الاسم علمًا أعجميًا مثل: “إبراهيم”، “إسماعيل”، “نوح”.
مثال: قابلتُ إبراهيمَ اليوم.
هـ. العلمية ووزن الفعل
مثل: “يزيد”، “يشكر”، حيث إنها على وزن أفعال.
مثال: تحدثتُ إلى يزيدَ.
و. العلمية والانتهاء بألف وتاء
مثل: “عرفات”، “طلحات”.
مثال: وصلتُ إلى عرفاتَ.
2. الوصف الممنوع من الصرف
يمنع الاسم الوصفي من الصرف إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:
أ. الوصف وصيغة “أفعل” الذي مؤنثه “فعلاء”
مثل: “أحمر”، “أصغر”.
مثال: مررتُ بطريقٍ أحمرَ.
ب. الوصفية والعدل عن صيغة أخرى
مثل: “أخر”، المشتق من “آخر”، وكذلك “أُولُ”.
مثال: قرأتُ قصة في الصفحة أُولَى.
ج. الوصفية وزيادة الألف والنون
مثل: “عطشان”، “غضبان”، “كسلان”.
مثال: رأيتُ ولدًا كسلانَ.
3. صيغة منتهى الجموع
وهي صيغة جمع تنتهي بألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوساطهم ساكن. مثال على ذلك:
- مساجد
- مدارس
- مصابيح
مثال في الجملة: شاهدتُ مساجدَ كثيرة في المدينة.
حالات صرف الممنوع من الصرف
المقصود بـ”صرف الممنوع من الصرف” أي أنه يُعامل كالمصروف (أي أنه يُجرّ بالكسرة) في حالات محددة. وهذه الحالات تُعد استثناءً لقاعدة المنع، ويكون فيها الاسم غير ممنوع من الصرف، بل يُصرف ويُعامل معاملة الاسم العادي.
وهذه الحالات كالتالي:
1. إذا عُرِّف الاسم بأل التعريف
إذا دخلت “أل” على الاسم الممنوع من الصرف، فإنه يُصرف، أي يُنَوَّن ويُجرّ بالكسرة. مثال:
كلمة: “مساجد” ممنوعة من الصرف، وعند إضافة أل إليها تصبح “المساجد”، فتُصرف.
أمثلة:
- ذهبتُ إلى المساجدِ.
- صليتُ في المدارسِ القديمة.
نلاحظ في المثال أن الكلمة جُرّت بالكسرة لأنها مُعرفة بـ”أل”.
2. إذا أُضيف الاسم إلى اسم آخر
عند إضافة الاسم الممنوع من الصرف إلى اسم بعده يُصرف أيضًا، فيُجرّ بالكسرة.
أمثلة:
- صليتُ في مساجدِ المدينةِ.
- تجولت في شوارعِ القاهرةِ.
في المثالين أعلاه، أُضيف الاسم الممنوع من الصرف إلى اسم آخر، مثل “المدينة” و”القاهرة”، لذا صُرفت الكلمة.
3. إذا كانت منصوبة جاءت منصوبة بالفتحة، سواء كانت معرفة أم نكرة
الاسم الممنوع من الصرف يُنصب بالفتحة مثل الاسم المصروف، سواء أكان معرفًا أم نكرة، ولا فرق هنا في حالة النصب.
أمثلة:
- زرتُ مصرَ.
- أحببتُ سليمانَ.
كلا الاسمين “مصر” و”سليمان” من الأسماء الممنوعة من الصرف، وقد نُصب بالفتحة في المثال لأنه في حالة نصب.
4. في حالة الضرورة الشعرية
في الشعر العربي، قد يُصرف الاسم الممنوع من الصرف أحيانًا تماشيًا مع وزن الشعر والقافية، وتُعد هذه الحالة من الضرورات الشعرية التي أجازها علماء اللغة.
مثال:
قال الشاعر:
“إن السماحَ على من يرجوهُ مُعتمدُ *** كَمِساجدٍ يُرفعُ فيها خاشِعٌ وردُ”
لاحظ أن الشاعر صرف كلمة “مساجد” بالرغم من أنها ممنوعة من الصرف.
أمثلة تدريبية للفهم
حدد في الجمل التالية الأسماء الممنوعة من الصرف:
- سافرت إلى لبنان.
- زرتُ مساجد المدينة القديمة.
- اشتركتُ في مسابقات فكرية.
- قرأتُ عن عمر بن الخطاب.
الحل:
- لبنان: ممنوع من الصرف (علم أعجمي).
- مساجد: ممنوع من الصرف لكنه قد صُرف لأنه أُضيف.
- مسابقات: ممنوع من الصرف (صيغة منتهى الجموع).
- عمر: ممنوع من الصرف (علم على وزن فعل).
أهمية فهم قاعدة الممنوع من الصرف
فهم هذه القاعدة يُساعد الطلبة على الكتابة والنطق السليم، ويُعزز من إدراك قواعد اللغة العربية، خاصة في التمييز بين الكلمات المصروفة وغير المصروفة. كما أن لهذه القاعدة دورًا في المعاجم اللغوية وفي ضبط النصوص الأدبية، مما يجعل تعلمها أمرًا ضروريًا ليس فقط لطلبة المدارس، بل ولكل من يتعلم اللغة العربية ويسعى إلى إتقانها.
قائمة المراجع
- شذا العرف في فن الصرف – أحمد الحملاوي
- النحو الوافي – عباس حسن
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
- موسوعة النحو والصرف – الدكتور فخر الدين قباوة
- مناهج وزارة التعليم في النحو العربي للمرحلتين الإعدادية والثانوية
موارد ذات صلة: