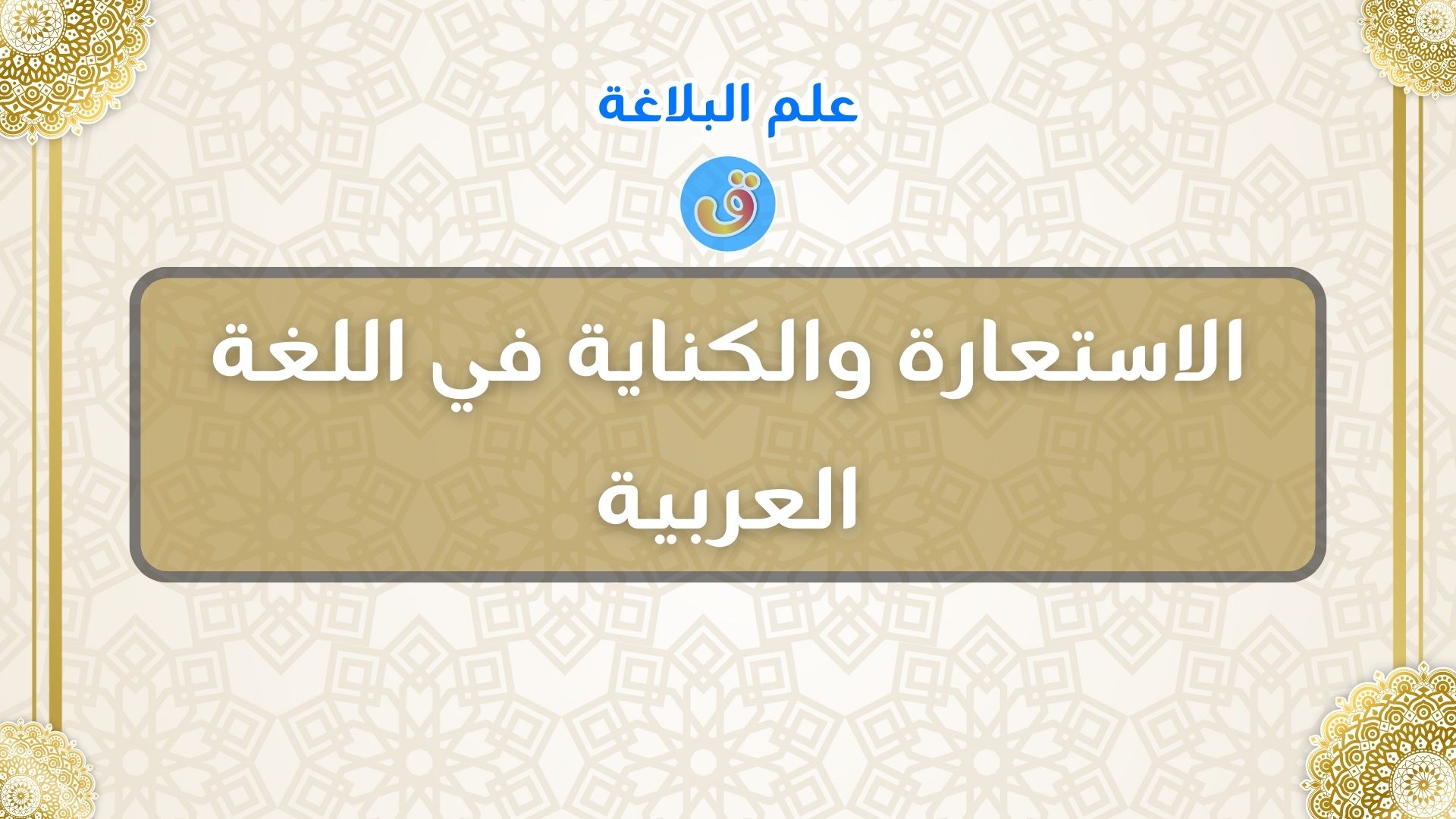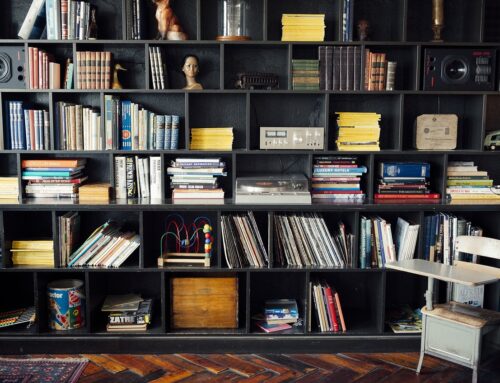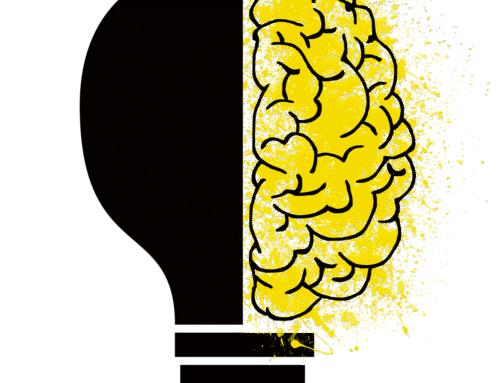ما هي الاستعارة والكناية؟
الاستعارة: هي نوع من أنواع الصور البلاغية التي تُستخدم في اللغة العربية لتجميل الكلام، ولإيصال المعنى بطريقة غير مباشرة ومبدعة. وهي تقوم على التشبيه ولكن بدون ذكر أحد أركان التشبيه بشكل صريح، وبخاصة أداة التشبيه والمشبَّه به. بمعنى أن الاستعارة تُبنى على تشبيه ولكن بحذف أحد الطرفين، وعادة ما يُذكر المشبَّه ويُحذف المشبَّه به، أو العكس، وتُذكر بعض صفاته لكي يُفهم منه المعنى المقصود.
مثلاً، عندما نقول: “نطقت الجدران بالحقيقة” فالجدران لا تنطق في الحقيقة، ولكن المقصود أنها أظهرت ما خفي، وهذا تشبيه للجدران بإنسان يتكلم، دون أن نذكر ذلك صراحة. إذًا هذه استعارة مكنية، حيث أُسند الفعل “نطقت” إلى “الجدران” على سبيل المجاز.
أنواع الاستعارة:
١- الاستعارة المكنية
الاستعارة المكنية تقوم على ذكر المشبَّه وحذف المشبَّه به، مع الاحتفاظ بشيء من خصائصه، وتُؤخذ الصفة أو الفعل المرتبط بالمشبَّه به وتُسند إلى المشبَّه. مثال:
“زأر البحر بأمواجه.”
“زأر” هو فعل يُنسب للأسد، فالبحر شُبِّه بالأسد في قوته وهدره، ولكن لم يُذكر “الأسد” في الكلام، بل أُبقي على صفته وهي “الزئير”، ولذا فهي استعارة مكنية.
٢- الاستعارة التصريحية
في الاستعارة التصريحية يُذكر المشبَّه به ويُحذف المشبَّه نفسه، بحيث يتم التصريح بالمشبَّه به على أنه المشبَّه. مثال:
“رأيت أُسْد الشجاعة في ساحة القتال.”
المقصود بالأسد هنا هم “الجنود الشجعان”، فقد تم تشبيههم بالأسود في الشجاعة، وذُكر المشبَّه به “أسد” ولم يُذكر “الجنود”، بل أُطلق اسم المشبَّه به عليهم. وهذه استعارة تصريحية لأننا صرحنا بالمشبه به.
أمثلة متنوعة على الاستعارة
١- “غضب الزمان علينا.” – الزمان لا يغضب، وإنما الحدث الذي وقع كأنه من الزمان.
٢- “تجمد الكلام على شفتي.” – الكلمة لا تتجمد، لكن لتصوير التردد أو الخوف.
٣- “فتحت الحياة أبوابها.” – الحياة لا تفتح أبوابًا حقيقية، بل المقصود أن الفرص أصبحت كبيرة.
الكناية: تعريفها وأقسامها
ما هي الكناية؟
تعبير يُقصد منه معنى غير مباشر، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي للَّفظ. أي أن الكناية لا تعتمد على الصور البلاغية والخيال مثل الاستعارة، بل تعتمد على الدلالة والإيحاء. وغالبًا ما تدل الكناية على صفة أو حالة أو نسبة.
فعندما نقول: “فلان طويل النجاد”، لا نقصد فقط أن نجاده (أي غمد سيفه) طويل، بل نقصد أنه طويل القامة. هذه كناية عن صفة، وهي الطول، وقد أتينا بالمعنى عن طريق رمز وإيجاز.
أنواع الكناية:
١- كناية عن صفة
تُستخدم للإشارة إلى صفة معينة دون ذكرها مباشرة. ومثال ذلك:
“فلان نظيف اليد.”
الكناية هنا تدل على الأمانة والنزاهة، أي أنه لا يأخذ الرشوة ولا يسرق، فبدلًا من قول “هو نزيه”، استُخدمت عبارة رمزية.
٢- كناية عن موصوف
المراد بهذه الكناية الإشارة إلى شخص أو شيء معين من غير التصريح به، بل بذكر شيء يرتبط به. مثال:
“يا ساكني أرض الكنانة.”
المقصود بـ”أرض الكنانة” هو مصر، وهي كناية عن موصوف لأننا أشرنا إلى “مصر” دون أن نذكر اسمها مباشرة.
٣- كناية عن نسبة
وفيها يتم الإشارة إلى نسبة صفة إلى شخص دون التصريح بها، بل بإيراد ما يدل على ذلك. مثال:
“الكرم ينام على وسادته.”
فالمقصود هنا أن الرجل كريم، وقد نُسبت إليه الصفة بطريقة إبداعية، فتم تصوير “الكرم” كأنه شيء ينام معه، للدلالة على شدة التصاق هذه الصفة به.
أمثلة على الكناية
١- “فلان كثير الرماد.” – كناية عن الكرم، لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ والضيوف.
٢- “فلانة بيضاء اليد.” – كناية عن البراءة والنقاء.
٣- “فلان لا ينزل له حُمْرة.” – كناية عن الشجاعة، أي أنه لا يستحي ولا يخاف.
٤- “فلان يجر ذيله فخرًا.” – كناية عن التكبر.
الفرق بين الاستعارة والكناية
رغم أن الاستعارة والكناية تتشابهان من حيث أنهما أسلوبان بلاغيان، إلا أن بينهما فروقًا مهمة يجب أن يعيها الطالب والمعلّم.
أولًا:الاستعارة تعتمد على التخيل والتصوير والتشبيه، فهي تستخدم التشبيه بشكل خفي. أما الكناية، فتعتمد على الإيحاء والدلالة، وقد يكون فيها المعنى الحقيقي صحيحًا أيضًا.
ثانيًا: في الاستعارة لا يجوز قصد المعنى الحقيقي، أما في الكناية يجوز أن يُفهم المعنى الحقيقي ضمن الكلام.
ثالثًا: الكناية غالبًا ما تكون ألطف في التعبير، وتُستخدم في الأوصاف الذمِّية أو المدحية بصيغة غير مباشرة، في حين أن الاستعارة تُستخدم لتقوية التأثير الفني والخيال.
إرشادات للمعلمين:
يمكن تدريب الطلاب على تمييز الكنايات والاستعارات من خلال قراءة نصوص قصيرة وتحليلها. وعلى مستوى متقدم، يمكن تشجيعهم على كتابة جمل تحتوي على استعارات أو كنايات من واقعهم اليومي، لتنمية الحس اللغوي ومهارة التعبير الإبداعي لديهم.
الاستعارة والكناية في الشعر العربي
لطالما كانت الاستعارة والكناية من أبرز الأدوات البلاغية في الشعر العربي القديم والحديث. فالشاعر يوظّف الاستعارة لتصوير مشاعره وتعظيم المعاني، ويستخدم الكناية للتلميح إلى معانٍ عميقة دون تصريح. ومن أشهر الشعراء الذين أكثروا من استخدام الاستعارة والكناية: المتنبي، وأحمد شوقي، ونزار قباني، وأمير الشعراء حافظ إبراهيم.
مثال من المتنبي:
“إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ .. فلا تقنعْ بما دونَ النجومِ”.
هنا استعارة في جملة “فلا تقنع بما دون النجوم”؛ حيث يُشبَّه الشرف بالنجوم العالية.
ومثال من أحمد شوقي:
“وإذا الأرحامُ قد نطقتْ .. فما لكَ بعدُ من عذرِ!”
هنا استعارة مكنية حيث تُسند “النطق” للأرحام، والمقصود أن الأقارب فضحوا ما كان يُخفى.
قائمة المراجع
- البلاغة العربية: علم المعاني والبيان والبديع – د. عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني.
- البلاغة الواضحة – علي الجارم ومصطفى أمين.
- موقع مجمع اللغة العربية بالقاهرة – قسم البلاغة.
- سلسلة التلميذ المبدع – الصفوف الابتدائية والإعدادية (وزارة التربية والتعليم المصرية).